
مقدمة
“وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ”
— سورة الصافات، الآية 107
منذ اللحظة التي رفع فيها إبراهيم عليه السلام السكين على نبي الله اسماعيل، ظلّ مشهد الفداء يتردّد في الذاكرة الإنسانية كعلامة على التوتر الأزلي بين المقدّس والعنف.
“وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ” — سورة الصافات، الآية 107 ✅
لم يكن مجرد حدث ديني، بل رمز تأسيسي للعلاقة بين الإنسان والخوف، بين الجماعة والنظام. من هذه اللحظة، بدأ ما يمكن تسميته بـ«تاريخ الضحية»، الذي سيُعاد إنتاجه في صور دينية، سياسية، وأخلاقية متعددة.
هذه المقالة تحاول أن تُعيد قراءة مفهوم الفداء في ضوء الفلسفة المعاصرة، انطلاقًا من تحليل رينيه جيرار في كتابه العنف والمقدّس، مرورًا بفرويد ونيتشه، وصولًا إلى فوكو ودريدا، لتُظهر أن الفداء لم يكن طقسًا دينيًا فحسب، بل آلية فلسفية-اجتماعية لتأسيس النظام عبر العنف الرمزي.
لماذا اخترعنا “كبش الفداء”؟
وقد افتدى الله إسماعيل بذبحٍ عظيم،
ونحن نعيد هذه السُّنّة كلّ سنة؟
الفداء كرمز ديني… لكن كيف؟
هل يحتاجك الرمز، أيّ رمز، أن تكون فداءً له؟
أولًا: من الطقس إلى البنية – قراءة في نظرية جيرار
قدّم رينيه جيرار واحدة من أكثر القراءات ثورية في فهم علاقة المقدّس بالعنف. في كتابه Le Sacré et la Violence (1972)، يرى أن كل مجتمع يحمل في داخله عنفًا بنيويًا مكبوتًا، لا يمكن احتواؤه إلا من خلال آلية رمزية تُعيد توجيهه نحو ضحية واحدة.
هذه الضحية ليست مختارة عشوائيًا، بل تُختار لأنها تمثل المختلف، الهامشي، أو الغريب الذي يمكن تحميله وزر الجماعة.
يقول جيرار: «نحن نُقدّم الضحية لا لنُرضي الإله، بل لنسكت خوفنا منه».
بذلك، تصبح الطقوس الدينية القديمة وسيلة لتفريغ العنف الجماعي، حيث يتمّ تحويل العدوان الداخلي إلى حدثٍ مقدّس يرمّم التوازن الاجتماعي.


ثانيًا: فرويد والذنب المؤسس – من قتل الأب إلى ولادة الضمير
قبل جيرار بنصف قرن، كان سيغموند فرويد قد طرح فرضية مشابهة في كتابه الطوطم والحرام (1913)، حيث افترض أن الجماعة البشرية الأولى قامت بقتل الأب البدائي، الذي كان يحتكر السلطة والنساء. وبعد القتل، اجتمع الأبناء على ندمهم، فحوّلوا صورة الأب إلى رمز مقدّس، وأسسوا له طقوسًا تمنع تكرار الجريمة.
بهذا، وُلد الدين كـ تذكير دائم بالجريمة الأولى، ووُلد الضمير كأثرٍ نفسي لهذا الندم الجماعي.
إن ما يسميه فرويد بـ«الذنب المؤسس» هو الوجه النفسي لما يسميه جيرار «العنف المؤسس». في كلا الحالتين، يقوم النظام الاجتماعي على جريمة أولى تُنسى في الوعي وتُخلّد في اللاوعي الجماعي.
وهكذا يصبح الفداء استمرارًا رمزيًا للقتل الأول، حيث تُكرّر الجماعة الطقس نفسه لتؤكّد براءتها منه.

ثالثًا: نيتشه – من الذبح إلى الأخلاق
في جينالوجيا الأخلاق (1887)، أعاد فريدريك نيتشه التفكير في جذور الأخلاق نفسها، ورأى أنها وُلدت من تحويل العنف إلى شعور بالذنب. الكلمة الألمانية Schuld تعني في الوقت ذاته “الدَّين” و”الذنب”، ما يعني أن الإنسان لم يتوقف عن ممارسة العنف، بل وجّهه ضد نفسه.
يقول نيتشه: «الضمير هو سكين مغروس في الذات».
بهذا، انتقل الذبح من الخارج إلى الداخل، من الضحية إلى الوعي، وأصبحت الأخلاق هي الشكل الجديد للدماء القديمة.
في هذا السياق، يمكن قراءة قصة إسماعيل بوصفها التحوّل الرمزي للعنف من الجسد إلى الوعي: حين يُستبدل الابن بالكبش، يصبح الفعل نفسه بداية ميلاد الضمير.
لكن التاريخ لم يحتمل هذا التجريد، فعاد الإنسان ليُعيد الذبح مرة أخرى — باسم الله، ثم باسم القانون، ثم باسم الأخلاق.


رابعًا: فوكو – من الضحية الدينية إلى الضحية السياسية
مع الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، يتحول مفهوم الفداء إلى مستوى آخر تمامًا: السلطة الحديثة.
فوكو يرى في كتبه المراقبة والعقاب وتاريخ الجنسانية أن المجتمعات الحديثة لم تتجاوز منطق التضحية، بل غيّرَت أدواتها. لم يعد الجسد يُقدَّم على المذبح، بل أصبح يُراقَب ويُؤدَّب داخل مؤسسات مثل المدرسة والمستشفى والسجن.
إنّ الدولة الحديثة في سعيها إلى الانضباط، خلقت نوعًا جديدًا من الضحايا: المنحرف، المريض، الخارج عن النظام.
وهكذا انتقل الكبش من المعبد إلى النظام السياسي، من القربان إلى العقوبة، من الذبح إلى المراقبة.
بعبارة فوكو: «لم نعد نُعدم الجسد، بل نُهذّب السلوك».
إنّ ما يبدو إصلاحًا هو استمرارٌ خفيّ للعنف نفسه — ولكن باسم “المصلحة العامة”.فداء
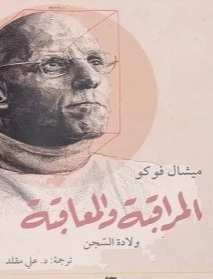
خامسًا: دريدا – الكتابة كفداء رمزي
جاك دريدا، في الكتابة والاختلاف، يعيد التفكير في التضحية من خلال اللغة.
الإنسان لم يتوقف عن ممارسة الفداء، لكنه حوّله إلى الكتابة.
الرمز، في رأيه، هو عملية “إرجاء” للعنف، حيث تتحول الرغبة في القتل إلى فعل لغوي: “نكتب ما لا نجرؤ على فعله”.
بهذا المعنى، تصبح الثقافة نفسها شكلًا من أشكال الفداء المستمر، إذ نحاول عبر المعنى أن نطهّر أنفسنا من أثر الدم الأول.
إن دريدا لا يلغى الفداء، بل يحوّله إلى تأويل لا نهائي للرموز. فالكلمة تحلّ محلّ السكين، والفكر يصبح المذبح الجديد الذي يُقدَّم عليه الجسد كفكرة لا كحقيقة.

سادسًا: من إسماعيل إلى كبش النظام
عبر هذا التسلسل التاريخي من إبراهيم عليه السلام إلى الدولة الحديثة – نرى أن الفداء لم يُلغَ قط، بل غيّر شكله.
ففي البداية كان ذبحًا جسديًا، ثم أصبح طقسًا دينيًا، ثم تحوّل إلى نظام أخلاقي أو قانوني، وأخيرًا إلى آلية رمزية وثقافية.
لكن جوهره واحد: الحاجة إلى ضحية تحفظ النظام.
كل مجتمع يعيش أزمة يبحث عن كبشه:
- في الدين كان الكبش حيوانًا.
- في السياسة أصبح المعارض.
- في الأخلاق أصبح المختلف.
- وفي الفضاء الرقمي أصبح من يُهاجَم على وسائل التواصل الاجتماعي.
الفداء الحديث لا يُقدَّم على المذبح، بل على “الشاشة”.
وهكذا، فإن ما يقدّمه جيرار ليس مجرد أنثروبولوجيا، بل فلسفة للنظام الاجتماعي نفسه: النظام لا يقوم إلا على “عنفٍ مؤسِّس” يُعاد تمثيله في شكل طقوس مقنَّعة.

سابعًا: إمكان الفداء الفلسفي – نحو تجاوز العنف المؤسس
لكن هل يمكن أن يوجد فداء بلا دم، نظام بلا ضحية؟
الفلاسفة المعاصرون يرون أن هذا ممكن فقط عندما يُستبدل الفعل بالوعي.
الرمز في معناه الأصيل ليس أمرًا للتنفيذ، بل دعوة للتفكير.
حين افتدى الله إسماعيل بكبش، لم يكن يطالب بتكرار الذبح، بل بإنهائه.
الفداء الحقيقي هو الوعي بأن العنف لا يُزيل الخوف بل يُعيد إنتاجه.
وعليه، فكل حضارة لا تُراجع رموزها، تُكرّر طقوسها دمويًا أو رمزيًا.
إنّ الفلسفة، بهذا المعنى، هي الفداء الأخير الذي ينقذنا من وهم الفداء نفسه.
🪶 كبش الفداء: لتكون كبش عليك أن تكون نقي!
في كلّ جماعةٍ صغيرة، في كلّ بيت أو علاقة أو دائرة اجتماعية،
يوجد دائمًا ذاك الشخص الهادئ… الودود… المتفهّم.
هو الذي يُصغي حين يتكلّم الجميع،
ويدافع عن الجميع،
ويفكّر في الجميع،
يعتذر من الجميع، وعن الجميع،
حتى عن الأخطاء التي لم يرتكبها.
يتحمّل العتاب بصمت،
ويبتسم كمن يطلب الصفح عن ذنوبٍ لا يعرفها.
وعند أول خطأ في المحيط العيون تتجه إليه ليكون “كبش الفداء”
يُتَّهَم دائمًا، متهم بدون خطأ،
حتى هو يُحاكم نفسه في صمتٍ داخلي طويل،
كأن عليه أن يبرّر للكون سبب طيبته المفرطة.
هو الضحية الدائمة التي تخلقها الجماعة لتظلّ مرتاحة،
لأنهم لا يحتملون رؤية أنفسهم في مرآته الصافية.
إنه ذاك الذي يسمّيه علم النفس الجمعي “كبش الفداء”،
ويسمّيه الوعي الفلسفي “الروح التي تُطهّر العالم بصمتها.”
ليس كبش الفداء بالضرورة مظلومًا بالمعنى الاجتماعي،
بل هو مظلوم بالمعنى الوجوديّ:
يُدان لأنه لا يريد أن يُؤذي.
يُتّهم لأنه لا يُهاجم.
ويُحمَّل الذنب لأنه النقيّ الوحيد في محيطٍ يحتاج إلى من يبرّر به قسوته.
كما قال كارل يونغ:
“حيثما يُنفى الظلّ، سيعود في صورة إنسان.”
وهذا الإنسان غالبًا هو “اللطيف”،
ذاك الذي يُسقط عليه الآخرون ظلالهم المكبوتة
عدوانهم، أنانيتهم، خيباتهم، وحتى ذنوبهم العائلية القديمة.
هو مرآة اللاوعي الجماعي،
التي تُعيد للنظام توازنه مقابل أن تفقد ذاتها شيئًا فشيئًا.
هل لاحظت يومًا أنّك الشخص الذي يُسارع إلى تهدئة التوتر حين يتصاعد؟
أنك تبادر بالاعتذار حتى حين لا تكون سببًا في شيء؟
أنك تصغي للآخرين وكأنك وُجدت لتكون لهم مرآةً لا صورة لها؟
هذه ليست مجرّد صفات لطيفة، بل علامات على أنك تحمل رمز كبش الفداء في البنية النفسية للجماعة.
كبش الفداء ليس دورًا يُختار، بل يُسند إليك ببطءٍ، عبر عواطف متكرّرة:
عندما يتعلّم الناس أنّك لن تغضب، يبدأون باختبار صبرك.
وعندما يرون أنّك لا تردّ، يُلقون عليك ما لا يريدون حمله.
وعندما تسامح، يعتادون ألا يطلبوا الغفران أصلًا.
أنت، ببساطة، صرت “الهدوء الذي يشتري به الآخرون سلامهم.”
لكنّ هذا السلام ليس لك.
إنه سلامٌ مُستعار من طاقتك، من صمتك، من تنازلاتك اليومية الصغيرة التي لا تُذكر… لكنها تتراكم.
علامات كبش الفداء ليست ضعفًا، بل برنامجًا اجتماعيًا دُرّبت عليه دون وعي:
أن تحبّ بلا شروط، أن تتنازل لتُرضي، أن تبرّر لتُفهَم، أن تُنقذ كي لا تتركهم يغرقون.
هي عملية “هندسة نفسية عاطفية”، صنعت منك محور التوازن النفسي للجميع…
إلا أنت.
وحين يبدأ وعيك بالاستيقاظ، تدرك أن اللطف الذي صنع صورتك في عيونهم
هو السجن ذاته الذي أخفى ملامحك الحقيقية.
حينها فقط، كما قال فرويد لتلميذه أدلر:
“الوعي بالألم هو أول خطوة للتحرّر منه.”
في تلك اللحظة، تفهم أنّك لم تُخلَق لتكون رمز الطمأنينة للآخرين،
بل لتكتشف أيّ سلامٍ تحتاجه أنت، بعيدًا عن ضجيج حبّهم المشروط.
هذه العلامات آليةٍ دفاعية تشكّلت منذ الطفولة.
حين يتعلّم الطفل أن الحبّ يُشترى بالطاعة،
وأن الهدوء يُنقذ البيت من الانفجار،
يتحوّل إلى منقذٍ صامتٍ للجميع.
يكبر وهو يحمل داخلَه قناعةً سرّية:
أن وجوده مبرَّر فقط إن كان يسكّن آلام الآخرين.
لكنّ هذا اللطف المستمرّ، كما يقول إريك فروم،
هو شكل راقٍ من الهروب من الحرية.
فالذي يرضي الجميع، لا يعود يعرف ما يريد.
والذي يداوي الجميع، ينسى جراحه القديمة حتى تتعفّن تحت الجلد.
تحوّله الأخير
يبدأ التحوّل حين ينضج الوعي.
حين يدرك كبش الفداء أنه لم يُخلَق ليكون وسادةً للآخرين،
بل كائنًا حرًّا قادرًا على قول “لا” دون أن يشعر بالذنب.
تلك “اللا” الأولى التي ينطقها بعد سنواتٍ من الصمت
هي، في جوهرها، لحظة ولادةٍ جديدة.
إنها لحظة تحوّل اللطف إلى وعيٍ ناضج،
حين يفهم أن الرحمة لا تعني الخضوع،
وأن الصمت لا يعني الغفران.
يقول نيتشه:
“من يطهّر نفسه من حاجة الآخرين إليه، يصبح سيدًا على مصيره.”
وفي تلك اللحظة، يتحوّل كبش الفداء إلى ما كان عليه في الأصل:
روحًا حُرّة لا تحتاج إلى إذنٍ لتكون.
حينها، تبدأ الجماعة بالارتباك.
فالنظام الذي كان قائمًا على طهره يبدأ في الاهتزاز.
ولأنهم لا يعرفون التوازن دون ضحيّة،
يتهمونه بالأنانية، بالتمرّد، بالغرور.
لكن الحقيقة أن المنقَذ لا يُفهم إلا بعد غيابه.
كبش الفداء لا يموت، بل يتحوّل.
كان مرآةً للآخرين، فأصبح مرآةً لذاته.
كان صامتًا ليحافظ على النظام، فأصبح صامتًا ليحمي روحه.
كان يُطهّر الآخرين من ذنوبهم،
والآن يتطهّر هو من حاجتهم إليه.
كما قال دوستويفسكي:
“النقاء قوّة لا يفهمها المذنبون.”
خاتمة
من إسماعيل إلى كبش النظام، يمتدّ خطّ واحد هو خطّ العنف المؤسس الذي يحكم علاقة الإنسان بالمقدّس، وبالسلطة، وبنفسه.
رينيه جيرار رأى أن المجتمع يحتاج إلى ضحية ليستعيد توازنه؛ فرويد كشف أن الضمير وُلد من قتلٍ منسيّ؛ نيتشه أظهر أن الأخلاق هي تحويل العنف إلى ذنب؛ وفوكو ودريدا أكملا المسار نحو تفكيك هذا العنف في اللغة والسلطة.
غير أن كل هؤلاء، بطرق مختلفة، يلتقون عند حقيقة واحدة:
أنّ الفداء ليس حدثًا ماضويًا بل آلية فكرية ونفسية تُعيد إنتاج النظام الاجتماعي عبر التضحية بالآخر.
الفلسفة إذن، حين تفهم الفداء، لا تسعى إلى إلغائه، بل إلى تعريته من القداسة التي تحميه.
فالفكر الذي يدرك أن الدم ليس طريق الخلاص، يصبح هو ذاته الفداء الأخير للإنسان من تاريخه الدموي.
«ليس الدم هو الذي يطهّر الأرض، بل الوعي هو الذي يطهّر القلب.»

.

مقالة فلسفية إنسانية رائعة واصلي نحتاجك.